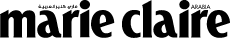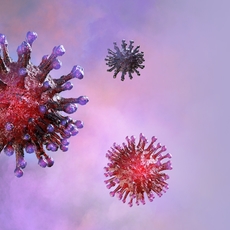Alissar Nasr :" الطالب يتعلّم عندما يدرك أنّ تعلّمَه هو لبناء شخصيّته، وليس إرضاءً لمحيطه "
- 05.05.2023
- إعداد: أرزة نخلة
كانت أليسار نصر في الثّامنة من العمر عندما يَمّمَ والدها نحو دبي، يومَها جاء إلى هذه الأرضِ الطّيبة بإمكاناتٍ ماديّةٍ محدودة، لكنْ كان في قلبِه وعقله حلمٌ كبير... حيث التقى برجال ثِقات جمعَهم الصّدق وحبُّ دبي، ورَغبةٌ عارمةٌ في البناءِ والتّطوير؛ فكانتْ وشراكةٌ أثمرتْ سلسلةَ مدارس المواكب. وفي هذه البيئة نشأت وترعرعت، وفي المواكب درست، ومنها تخرّجت. وقد تركتْ خبرة والدها في مجال التّعليم بصمةً عميقة في حياتها. فمنذ صغرها أحبّت أنَ تكون معلّمة، ولهذه الغاية توجّهت إلى الولايات المتّحدة الأمريكية حيث درست في جامعة Case Western Reserve University ونالت منها درجة بكالوريوس في مادة الريّاضيات، لتعودَ إلى المواكب معلّمةً لمدة ثلاث سنوات، قبل أن تتابع الماجستير في جامعة هارفرد (Harvard) لتعود من جديد للعمل الإداري والأكاديمي في المواكب! وهي أصبحت ما هي عليه اليوم من خلالِ الأسئلة والحواراتِ الدائمة مع والديها. أباها وأمّها: نبيل ونزيهة نصر، اللذان كانا هما المدرسة والجامعة في حياتها... كانا "هارفرد" الحقيقيّة بالنسبة إليها. وفي الحوار التالي نسأل أليسار نصر المديرة الأكاديمية لمدرسة المواكب ومؤسسة مبادرة صدى آمسي عن التغيّرات في قطاع التعليم واحتياجات الأطفال للتعلّم في عصرنا ومواضيع أخرى ذات صلة!

- كيف برأيك تطوّرت ذهنيّة التعليم في مدارس الإمارات العربيّة والمنطقة عمومًا في العشرين سنة الماضية؟
شهدت الرّؤية إلى التعليم في الدّولة خلال العشرين سنةً المنصرمة تطوّراتٍ مذهلةً في شتّى المجالات، لعل أبرزَها ذلك التحوّلُ من التركيز على التعليم، إلى التّركيز على التعلّم، ومن التّركيز على المدرّس إلى التركيز على الطالب.. وممّا ساهم في دفع عجلةِ التطوّر، إدخالُ وسائل تعلّم وتعليم وتقنيّات تكنولوجيّة جديدة ومعاصرة، فضلا عن سياسة الدولة باستقدام كوادرً ومؤهّلاتٍ تربويّة مرموقة من الخارج، والإفادة من طاقتها، وصولا إلى احتضان المواهب، والكفاءات المحليّة، وتنميتها وتطويرها.. إن تطوّر ذهنية التعليم في المؤسسات التربويّة، هو من انعكاساتِ رؤية الإمارات.. هو من تلك التوقّعات المرتفعة التي تضعها دولة الإمارات العربيّة المتحدة وتطالبك فيها بالتميّز وتدفعك دائمًا للبحث عن كلِّ جديد ومبتكر ومتطوّرٍ ونافع كي تعتمده، دونما مَساسٍ بالأساس الذي هو الطالب وتطوّره الشّخصي والاجتماعي، فضلًا عن تحصيله الأكاديمي. وكم نحن محظوظون أننا في دبي التي بقدر ما تعطيها تعطيك، دبي التي تسعى أبدًا الى التميّز وتدعم السّاعين إليه بلا حدود. نعم، إنّ مواكبة التوقّعات المرتفعة التي تضعها دولة متطورة من طراز الإمارات، تجعلك في حالة استعداد وحضورٍ دائمين لمواكبة التطور والسير في ركبه.. فالإمارات من خلال رؤيتها وممارساتها تشجّع المؤسّسات والأفراد على المُضيّ في طريق التجديد والتطوير ولا تجعلهم خائفين منه.

- ما التّحديّات التي لاحظتها في القطاع التعليمي في السنوات الأخيرة؟ وما هي التغيّرات التي طرأت في المدارس للاستجابة لتلك التحديّات؟
إنّ أكبر تحدٍّ تواجهه المدارس برأيي، هو تأمين الموارد البشريّة الكفوءة لاسيما المعلمين، فالمعلم باعتقادي هو محور المدرسة، وهو أعظم ثروة فيها لأنّه مصدر العطاء.. طبعًا الطالب هو الثروة المستقبلية.. أما الذي يصنع التغييرَ في الطّالب ويحقّقُ رؤية المدرسة، فهو المعلّم.. والتّحدي الذي أتحدّثُ عنه هنا، لا يكمن في استقطاب الموارد البشريّة الكفوءة فحسب، بل في العمل على تطويرها وتنمية مهاراتِها لتواكبَ رؤيةَ المدرسةِ ومبادئَها لناحية تطوّر الطالب، فضلًا عن رؤية البلد الذي يحتضن تلك المدرسة. عمليةُ التطوير المهني للمدرسين اليوم لم يعدْ ترفًا أو خيارًا، بل أضحت جزءًا لا يتجزّأ من أولويّات المدارس واهتماماتها وهُويّتها. إن التطوير المهني للمعلمين لا ينعكس إيجابًا على التطور الأكاديميّ للطلبة فحسب، بل يسهم في تنمية تطورهم الشّخصيّ والاجتماعي.. وهذا النّوع من التطور هو ما حرصت المواكب منذ نشأتها على تحقيقه كهدف ارتبط بنهجها ورسالتها، وكان وما يزال عندها من الأولويات..
فعلى سبيل المثال، عندما كنت طالبة في المواكب كنت أدرك أن النشاطات التي تدمج الطلبة وتظهر مواهبهم الفردية، هي جزء من هوية هذه المدرسة؛ لذلك رأيت ضرورة إدراج هذا الموضوع في برامج التطوير المهني .. اليوم باتت المدارس الأخرى تدرك أهمية التطور الشخصي والاجتماعي للطلبة، وتدرك محورية الأنشطة في تحقيق هذا التطور؛ وهذا يثلجُ صدورَنا. التطوير المهني للمعلمين، أحدثَ تحوّلًا جذريًا في عملية التعليم، ونقل أداء المعلم من التلقين إلى البحث عن طرائق واستراتيجيات تُلبّي احتياجات الطلبة التعلّمية وتحقق تعلّمًا فعّالا محوره الطالب الذي يسّهل المعلّم إجراءات تعلّمه. التحدّي الثاني كان جائحة كورونا وما حملته إلينا من مشاكل .. قد يظن البعض أنّ تحديّات الجائحة كانت على الصعيدين الأكاديميّ والتكنولوجيّ وتمثّلت في كيفيّة الوصول بالمادة التعليميّة إلى الطلبة في منازلهم، لكن التحدّي الأساسيّ والأهم بنظرنا، كان معالجةَ الآثار الاجتماعيّة والنفسيّة التي تركتها الجائحة على الطلبة والمعلمين معًا؛ لذا كنا نتواصل مع كل طالب للاطمئنان إلى وضعه الاجتماعيّ والنّفسيّ في تلك الأوقات الصعبة، ولمدِّ يد العون إليه في هذا المجال أيضًا.. ولهذا كان التركيز خلال اجتماعاتنا الإدارية على إيجاد أفضل السبل لمعالجة هذا الأمر، فضلا عن الفجوة الأكاديميّة وفَقْدِ التّعلّم الذي أحدثته الجائحة. أما التحديّات التكنولوجيّة، فقد اكتشفنا أنها أسهل بكثير من الأولى، فالأهداف التكنولوجيّة التي كنّا نظن أنها تحتاج إلى عشر سنوات كي تتحقق، تمكنا من إنجازها في غضون شهر فقط، ولعّل الفضل في هذه الجهوزية، يعود إلى دبي وإلى التوقعات المرتفعة التي تضعها لمؤسساتها وأجهزتها.

- شكّلت جائحة كورونا مفترق طرق في استخدام التكنولوجيا في تعليم الأطفال، فما هو رأيك بتلك الاستخدامات وهل تبعدهم عن الأعمال اليدويّة والحسيّة؟ أو تتكامل معها؟
لعلّ من أبرز مؤشرات الفعل الإنساني النّاجح في الحياة بشكل عام والمؤسسات بشكل خاص، هو القدرة على تحويل المشاكل والنكبات إلى فرص للتطور والنّمو.. هذه القاعدة الذّهبية في علم الاجتماع، لمسناها لمس اليقين في إبّان الجائحة التي على الرّغم من الأضرار والآلام العميقة التي تركتها في العالم أجمع، إلا أنها في الوقت عينه شكلت لنا تحدّيًا كبيرًا جعلنا نتكيّف مع المستجدات والضّرورات ونستأنف عملية التطوّر والنمو.. وقد ترافق هذا التّكيّف مع القلق المستجدّ من تحدي استخدام التكنولوجيا في التعليم وتأقلم البيئة المدرسية عليه، والذي كان بنظرنا مصدره الأهل والمدرسون، أكثر من الطلبة الصغار لأنّ التكنولوجيا هي عالمهم، وقد أثبتوا سرعة عجيبة في تلّقفها والإفادة منها كأداة للتعلّم. أمّا الشقّ الثاني من السؤال، هل التكنولوجيا تبعد الطلبة عن الأعمال اليدوية؟ فذلك برأيي يعتمد على طبيعة قرارِ الجهة التي تضع التكنولوجيا بين أيدي الطلبة، واستراتيجية استخدامها وأماكن ذلك الاستخدام وأوقاته؛ فالمدرسة مثلًا هي التي يجب أن تقرر متى وكيف يستخدم الطالب التكنولوجيا كأداة للتعلّم، ومتى وكيف يمارس الأنشطة والأعمال اليدوية وغيرها.. التكنولوجيا إذا، هي قرار بأيدي الكبار سواء أكانوا مدرّسين أو أهلًا.. طبعًا التكنولوجيا تبعد الطالب عن الأعمال اليدويّة إذا أسأنا اتّخاذ القرار بشأن استخدامها وتنظيمها.. يكثر الحديثُ اليوم عن مساوئ استخدام التكنولوجيا على النّاشئة من النواحي الصّحيّة والذهنيّة والنفسيّة، مقارنة بالحديث عن المنافع المكتسبة من استخدامها كمسّرع من مسرّعات التعلّم والبحث.. برأيي يجب أن يكون محور الحديث هو منافع استخدام التكنولوجيا، لأنّنا بذلك ندفع الناشئة لتركيز تفكيرهم على هذه المنافع وسبل تطويرها. الأمر كلّه برأيي هو مسألة قرارٍ، وحسنُ تنظيم وتوقيت..
فمن خلال تجربتي الخاصّة كأم مع هذه المسألة، كنت أفيد من التكنولوجيا لتحفيز أولادي على القراءة والبحث، كأن أقول لأولادي مثلا: إذا قرأتم في كتاب لمدة ساعة، فسأسمح لكم باستخدام الألعاب الإلكترونية لمدة نصف ساعة.. كذلك كنت أوزّع عليهم أسماء أعلام من مثل: جبران خليل جبران، المعرّي، المتنبي الشيخ زايد، الشيخ راشد... وأكلفهم بجمع معلومات عنهم لتكون هذه المعلومات موضوع حديثنا على مائدة الإفطار أو بعده..
- إلام يحتاج الأطفال اليوم لتحسين قدرتهم على التعلّم؟
أوّل ما يحتاج إليه الطالب برأيي حتى يتعلم بشكلّ فعّال، هو الإحساسُ بالأمان، جسديًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.. في بيئة يشعر فيها بأنّه يُقدَّرُ ويُحترم كإنسان، دونما سخرية أو تهشيم، في بيئة لا تتقدّم فيها درجات التّحصيل رغم أهميّتها، على وضعه النّفسي.. الطالب يتعلّم عندما يدرك أنّ تعلّمَه هو لبناء شخصيّته، وليس إرضاءً لمحيطه.. عندما يتحقّق الإشباع الرّوحي والنّفسي عند الطالب؛ تبدأ عمليّة تعلّمه الفعّال، ويبدأ بتحقيق إنجازاتٍ مُرْضِيَة، بل مُدهشة في أدائه الأكاديميّ. أعتقد أن التعليم الجامعي وسياسة القبول في الجامعات ستركز في المستقبل على المقابلات؛ لقياس مؤشرات التطور النفسي والاجتماعي عند الطالب، أكثر من محصّلة الدرجات.. وهنا تعود بي الذاكرة إلى هارفرد (Harvard)، أذكر أنَّ من بين الأسئلة الكتابية التي وجّهتْ إليّ في اختبار القبول: "نحن نعرف ماذا سنقدم لك في هارفرد، لكن ماذا ستقدمين أنت لهارفرد؟ " من الواضح أنّ غائية السؤال، لم تكن لقياس المهارات الأكاديمية بقدر استهدافها للسّمات الشخصية عند الطالب، وهذه السمات هي بالطبع من مفاعيل التطور النفسي والاجتماعي الذي يحققّه الطالب في بيئة يشعر فيها بالأمان. أذكر أن إجابتي عن ذلك السؤال يومها: سأتابع رسالة والدي، فأعملُ مربّيةً للأجيال، وسيكون أثري في طلبتي كأَثر أبي عليّ.

- هل معاملة كلّ التلاميذ بالطريقة عينها سواء تمتّعوا بقدرات كبيرة أو عانوا من صعوبات تعليميّة من دون تمييز مفتاح لدمجهم سويّاً وتنمية قدراتهم معاً أم أنّ هناك تقنيّات تعليميّة طوّرها العلم لمساعدة المعلّمين والمعلّمات على التعامل مع حالات مشابهة في الصف الواحد؟
ثمّة قاعدة في علم النفس أرساها الفيلسوف الألماني إريك فروم وأفادت منها النظريات التربوية بشكل كبير، تقول: كلّ إنسان، مثل كلّ الناس، وكلّ إنسانٍ مثلُ بعض الناس، وكلّ إنسان نسيجُ وحده، أيّ إلى جانب القواسم المشتركة التي يتقاطع حولها البشر جميعًا، إلا أن مبدأ الفرادةِ هو صفةٌ إنسانية جعلها الله لصيقة بالإنسان تميّزُ فردًا عن آخر.. وهذه القاعدة "النفستربوية" إذا صحّ التعبير، يجب أن يعمل بها التربويّون من خلال تطبيق مبدأ "التّمايز في التعليم"، أو ما يعرف بمراعاة الفروق الفردية التي لا يقتصر التركيز فيها على المستويات المعرفيّة والمهاريّة فحسب، بل على أنماط تعلّم الطلبة أوّلاً: السّمعيّة منها، والبصرية، والحركيّة، والتأمّلية وغيرها... ولتطبيق التعلّم والتّعليم المتمايز، لا بد من إجراء إحصاءات ودراسات فردية لاحتياجات الطلبة وأنماط تعلّمهم.. فكم يخطئ المعلمون عندما يحكمون على الطالب من خلال درجاته فقط! وكم من طلاب يتوقّعُ منهم معلموهم أداءً منخفضًا، ثم يدهشونهم بإنجازات تحمل ملامحَ إبداعيّة! من هنا تأتي ضرورة مراعاة التّمايز في التعليم، وضرورة التطوير المستمرّ لمهارات الكوادرِ التعليمية والقيادية على السواء؛ لتحقيق هذا الهدف، فعلم التربية يشهد تطوّراتٍ مضطردةً في هذا المجال، لذا على المؤسّسات التعليميّة أن تبقى دائمة التعلّم ومواكبةً لتلك التطوّرات.
في فترة الجائحة كانت لنا في مدارس المواكب تجربةٌ خاصّة تقوم على استراتيجية "التعلّم بالمشروع"، من خلال مشاريع الــ Capstone، وقد أثبتت لنا تلك التجربة أنّ تلبية الاحتياجات الفرديّة في التعليم، قد أدّت إلى نتائج مبهرة عند طلبة انطلقوا وأنجزوا، وما كانوا ليحققوا ما حققوه لو لم يُراعَ في تعليمهم نمطُ تعلّمهم الخاص، ومن بين هؤلاء، طلبةٌ من أصحابِ الهمم الذين نطبّق دمجَهم في برنامج تعليمي ضمنَ بيئة تعلّم مشتركة قادرة على توفير الدّعم، ممّا يزيل العوائق التي تقصيهم عن العملية التّعليمية، وتضمن لهم في الوقت عينه، الحصولَ على تعليم يلبّي احتياجاتهم المتنوعة بفعالية وبأساليب قائمة على القبول والاحترام. تلك التجربة أكّدت لي ما أنا مؤمنة به أصلًا من ضرورة دمج أصحاب الهمم في بيئة تعلّم مشتركة، وسياسة الدولة تُجاه هذا الموضوع، هي مدعاةُ فخر بالنّسبة إليّ.

- هلّا أخبرتنا أكثر عن مبادرة صدى آمسي وكيفيّة تأثيرها على حياة التلاميذ؟ ولماذا نحتاج إلى مزيدٍ من المبادرات في منطقتنا؟
لعلّ من أكثر ما نعتزُّ به في عملنا التربوي هو العلاقة التي نبنيها ونثابرُ عليها مع طلبتنا وخرّيجينا، علاقة تغرس فيهم حسَّ الانتماء إلى المواكب والولاء لرسالتها، وتنمّي في نفوسهم ثقافة العطاء.. وما صدى آمسي [AMSI Voice] سوى نموذج لمجموعة من القيم المواكبيّة التي يجسدها خرّيجونا في مبادرات يتوجّهون بها إلى طلبة المواكب؛ من أجل النّفع والتّنوير. يعود تاريخ صدى آمسي إلى العام 2016 وهي مبادرة أطلقها خرّيجون مواكبيّون لديهم خبرات حياتيّة ومهنية، أحبّوا أن يعطوا وأن ينقلوا خبراتهم وتجاربهم ومهاراتهم إلى الطلبة المقبلين على التخرّج. لقد بات في سجل صدى آمسي حتى اليوم، تسع مؤتمرات والعشرات من ورش العمل والتّدريب. أما عن أثر المبادرة على حياة الطلبة، فيتجلّى في تهافتهم على حضور مؤتمراتها والمشاركة في ورش العمل التي تنظمها.. ولعل من أجمل العبارات التي أسمعها من الطلبة بعد تلك المؤتمرات وورش العمل، وتلخّص أثَر المبادرة في نفوسهم: "مس أليسار"، في يومٍ ما ستتصلينَ بي وتطلبين مني أن أكون واحدًا من الضيوف". فهل من أثرٍ أروعَ من أن يصبح أصحابُ المبادرة وضيوفُها، قدوةً للطلبة المقبلين على التخرّج يحتذون طريقهم ويحلمون أن يصبحوا مثلهم؟! الخرّيجون برأيي هم ثروةٌ لم تكتشفها معظم المدارس بعد، وممّا نفخر به في المواكب أنّنا كنا السبّاقين إلى اكتشاف هذه الثروة والإفادة من طاقاتها الهائلة في تعميم ثقافة العطاء ونشر التنوير؛ ففي مدارسنا مكتب خاص لشؤون الخريجين - وربما نكون الوحيدين في هذا - يعملُ على التواصل مع جميع الخريجين ويتابع ويدعم نشاطاتهم، ويؤطّر طاقاتهم لتعميم النّفع. دائمًا أقول وأكرّر" إنّ قصتنا مع طلبتنا لا تنتهي بالتخرّج، بل تستمرّ بعده"، وما أجملَ هذا الاستمرار، وما أعمق أثره! .. وكم مجتمعُنا- لا سيما القطاع التربوي فيه - بحاجة إلى المزيد من المبادرات المماثلة! فلدينا أجيالٌ تنمو وتحتاج باستمرار إلى الكثير من الإرشاد والتوجيه. وثمّةَ أثرٌ آخرُ وفريدٌ لصدى آمسي، يتمثّل في أنّ الطلبة المقبلين على التخرّج يطّلعون على تجاربَ طلبةٍ مثلِهم سبقوهم وكانوا يجلسون على المقاعد التي يجلسون هم عليها اليوم. إن الطلبة بحاجة ماسّة كي يطّلعوا على الكثير من التجارب والخبرات والممارسات، وليس بالضرورة أن يكون مصدر هذا الاطلاع، هم الأهلُ والمعلمون حصرًا.

- ما هي نصيحتك للأهل اليوم، لأفضل متابعة لأولادهم تحافظ على صحّتهم النفسيّة؟ وماذا تقولين لهم عن التوقّعات التي يفرضونها على أولادهم خصوصًا لناحية النتائج المدرسيّة؟
نصيحتي إلى الأهل، أنِ استمعوا دائمًا إلى أولادِكم ولا تغرقوهم بالنّصائح، اتركوا لهم وقتًا ليحكوا لغتهم، أعطوهم مساحةً آمنة يرتاحون فيها ويطمئنون. أنا لست مع الرأي القائل:" إنّ على الأهلِ أن يكونوا أصدقاء لأولادهم"؛ فلأولادنا أصدقاءُ من عالمهم، لا يجوز لنا أن نأخذ منهم هذا الدور. أرى أننا كأهل، يجب أن نكون لأولادنا القدوةَ والمثال الذي به يثقون، وإليه يطمئنون، وبسلوكه يقتدون، المثال الذي يطبّق ويتمرّس عمليًّا بكل ما يطلبه منهم. وإذا ما واجهنا معهم مشاكل معيّنة، لا سيما ما يتعلّق منها بالشّق النفسي أو التربويّ، فليس من الضّروري أن تكون حلولُ تلك المشاكل كلِّها عندنا؛ قد نستطيعُ حلّها.. وقد لا نستطيع. وليس من الضروري أن نكونَ كأهل عارفين بكلّ شيء؛ لذا يجب أن نلجأ في هذه الحالة إلى ذوي الاختصاص وليس في ذلك عيبٌ على الإطلاق.. حبذا أن نعلّمَ أولادَنا، أنّ طلبَ المساعدة ليس عيبًا، فكما هم يطلبون مساعدتَنا، نحن أيضًا نطلبُ المساعدة من أصحابِ الخبرة إذا لم تكن لدينا الأدوات والقدرات الكافية للحلّ. علينا كأهل أن نتحلّى بالشّجاعة الكافية لكي نغيّر من الطرائق التي نتعامل بها مع أطفالنا، فإذا وجدنا أنها لم تجدِ معهم نفعًا، أو لا تأتي بالنّتائج التي نتوخّاها؛ ففي هذه الحالة يجب ألّا نبقى مُتَشبّثين بالأساليب والطرائق التي لم تُنتجِ التغييرَ المطلوب... أما في مسألة توقّعات الأهل من أبنائهم، فأقول: لا تفرضوا توقّعاتِكم أنتم على أبنائكم، لأن تلك التوقّعات كثيرًا ما تتحوّل إلى ضغوطاتٍ عليهم، ومشاكلَ تعيقُ طريقَهم.. أدركُ أنّ للأهلِ أحلامًا يحبّون أن يروها مُحقّقة في أولادهم، لكنّني في الوقت عينه لا أحبّذ التوقعّاتِ الصّارمةَ التي يحدّدها الأهل لأبنائهم لا سيّما في مجال النتائج المدرسيّة.. حبذا أن تَتَحوّل تلك التوقّعات إلى حوارات مع الأبناء والبنات، كأنْ نقول لهم مثلا: أتوقّع منك يا بُني، أن تكون مستقيمًا في خلقك،
صحيحًا في جسِدك،
سعيدًا في حياتك نفسيًّا واجتماعيًّا،
راضيًا عن ذاتك..
أن تكونَ عطوفًا، رؤوفًا، شكورا...
هذه توقعاتي منك، وهذا هو حلمي فيك.
أقول دائمًا في لقاءاتي الأهل: حبّذا أن نسترجعَ نحن علاقتِنا بأهلنا عندما كنّا في مثل سنِّ أولادنا، ولننظرْ في التّوقعات التي كانوا يضعونها لنا، ولْنُقَيِّم أثرَها فينا وعلينا؛ كي نستفيدَ مع أولادنا من إيجابيّاتها ونبتعدَ عن سلبياتها.