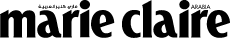التصوير: Tiffany Mumford
الإدارة الفنيّة: Farah Kreidieh
فور دخول منزل Zena Assi الذي يبعُد 15 دقيقة بالقطار عن وسط لندن والواقع حيث تطرب الطيور السامعين بتغريدها طوال اليوم، أوّل ما يأسر ناظريك هو مقدار الضوء المتدفّق عبر كافّة أرجاء المنزل. إذ يتغنّى منزلها بافتقاره إلى الممرّات، والزوايا المظلمة وحتّى الزوايا المستقيمة. بحيث يمكن لفنّانتنا تحضير قهوتها في المطبخ بينما تشاهد ابنها وهو يدرس في غرفة المعيشة أو بناتها يسترخين في الحديقة... غير أنّ أكثر ما يهمّ هذه الفنانة اللبنانيّة هو أن تتمتّع بمساحة تسمح لها بالتنفس والاسترخاء وإحاطة نفسها بمجموعاتها. ومن أثمن ما تحبّ عرضه أمام عينيها هي مجموعتها من القصص المصوّرة ومجموعة الفينيل الخاصّة بابنتها، بالإضافة إلى كتبها ونباتاتها ... اتبعينا إذاً في هذه الرحلة إلى منزلها في ضواحي لندن لنكتشف معاً كيف تمكّنت من جعل مشغلها امتداداً طبيعيّاً لمكان عيشها.
ما المهمّة الفنيّة الأكثر صعوبةً أم غرابةً التي نجحت في إتمامها؟
كلّ مرّة أشعر فيها بأنّني ما زلت ضمن منطقة راحتي، أجبر نفسي على الخروج منها وتحدّي أفكاري ومهاراتي. فعلى سبيل المثال، قرّرت المغامرة في الأشهر القليلة الماضية واختبار تقنيّة التنميش، لذا أمضيت وقتي في ممارسة تقنيّة الطباعة القديمة هذه والتعلّم من أخطائي في استوديو للطباعة في لندن. غير أنّه كان من المشوّق جداً لي أن أكتشف كيف مارس المعلّمون القدامى أمثال Goya وDürer التنميش والنقش بالحفر المائي على الألواح المعدنيّة. من هنا، قرّرت أن أضع نفسي في البيئة عينها واستخدام التقنيّات التي استخدموها مع الأحواض الحمضيّة لتقطيع المطابع النحاسيّة وتلك القديمة قبل طباعتها. أمّا الآن، فأخوض مغامرة أخرى عبر مشروع جديد، في حين أحوّل مناظر مدينتي إلى تطريزات. فلطالما كنت مفتونة بالحرفيّة، ويهمّني اليوم دمج الطرق التقليديّة القديمة في الأعمال المعاصرة. وصحيح أنّني لا أعلم كيف ستبدو النتيجة النهائيّة، غير أنّني أعتبر هذا الجزء الأكثر تشويقاً في الأمر.
حين تعملين على لوحة معيّنة، ما القواعد والعادات الشخصيّة التي تأخذينها بالاعتبار؟
لا أرسم قطّ أيّ رسومات تمهيديّة، بل أمثّل دافعي الأوّل مباشرةً في لوحاتي دائماً، فهكذا تجسّد أعمالي عفويّتي وردود أفعالي الفطريّة. لكن بالمقابل، دائماً ما أترك مجال لحصول الأخطاء والحوادث، فبهذه الطريقة أفاجئ نفسي في كلّ مرّة.
أمّا عادتي الوحيدة، فهي تواجدي في مشغلي كلّ يوم عند عملي على قطعة معيّنة. والرائع أنّ مشغلي يشكلّ امتداداً لمنزلي، ممّا يسمح لي بدخول إليه والخروج منه طوال اليوم وحتّى وقت متأخّر من الليل. كذلك، أحاول تجنّب أخذ فترات استراحة، لأنّ إلهامي يساورني حين أستمر في عملي بدون توقّف. والقاعدة الوحيدة التي أتّبعها هي عدم الخوف من تلف أيّ من أعمالي. فأستمرّ في تحويل تحكّمي بين العمل الذي أطوّره من جهة وتدخّلي به من جهة أخرى، لكن في الواقع أنّ الأعمال لا تتكلّل كلّها بالنجاح وأنا مدركة لهذا الواقع.
تشتمل خزانة ملابسك كما لوحاتك على خلفيّة سوداء مع لمسات خفيفة من الألوان الدافئة الساطعة. ما الذي يكشفه هذا القاسم المشترك عن شخصيّتك؟
يمكنني دمج كلّ الألوان بدون استثناء في أعمالي، غير أنّ استلهامي من محيطي ينعكس مباشرةً على أعمالي. فعلى سبيل المثال، حين عملت في لبنان، نالت الكابلات الكهربائيّة والفوضى والمباني الاسمنتيّة وحركة المرور نصيبها العادل في مظهر اللغة التي اعتمدتها في تلك الفترة. أمّا هنا في لندن، فاختلف الضوء والألوان وحتّى الفصول التي يمكن رصد تغيّرها الكامل حيث أعيش. وقد بدأ ذلك كلّه يتجلّى في باقاتي وربّما ملابسي، بحيث بات التباين أكثر وضوحاً فيها تماماً مثل الطقس. وأعتقد أنّ شخصيّة المرء وحالته المزاجيّة تنعكس دائماً في أعماله، لا سيّما حين يكون هذا كلّ ما يفعله طوال اليوم. ذكّرني سؤالك هذا بقصّة سأسردها عليك وعلى القرّاء. يحكى أنّ النحّات السويسري Alberto Giacometti وصف منحوتة "الكلب" خاصّته من العام 1951 على أنّها شكل من أشكال الصورة الذاتيّة، ورأى نفسه على هيئة كلب نحيل يمشي منحني الرأس على طول الجدران وتحت المطر. من البديهيّ بعد معرفة هذه القصة، أنّه من غير الممكن النظر إلى المنحوتة بدون رؤية جوانبها الإنسانيّة.
كيف تتجلّى ثقافتك اللبنانيّة العربيّة في لوحاتك وكيف تحاكي النساء العربيّات برأيك؟
ولدت وترعرعت في لبنان، ولم أغادر وطني قبل عمر الأربعين. لكن المؤسف أنّه ثمّة علامات تحدّد هويّة المرأة اللبنانيّة والعربيّة، وعلى كلّ امرأة منّا أن تخوض معركة أكبر في سبيل إيجاد مكانها اجتماعيّاً ومهنيّاً. إلّا أنّني أعتقد أنّ هذا الواقع يجعلنا أكثر مرونةً. فثقافتنا التي تعود إلى الأزمان القديمة تستمدّ غناها من تاريخها، ونحن نعتبر سيرنا بين الآثار الرومانيّة ومرورنا بالقرب من الجدران الفينيقيّة في روتيننا اليومي مجرّد أمر مفروغ منه... من هنا، أحاول تصوير هذا المشهد الملوّن في رسوماتي لوجوه الأشخاص والتعبير عن الطبقات الكثيرة اللازمة لوضع المرأة العربيّة على أيّ لوحة بدون تصويرها بصورة مثاليّة جداً أو إدانتها. فإذا ما نقلت الواقع المباشر لمحيطي، ستتجلّى قصص النساء اللواتي فيه تباعاً وبدون أيّ عناء. وأعتزّ باهتمامي الكبير بالقصّة الكامنة وراء هذا الموضوع، لذا، أحاول أن أنقل العلاقة بين الهجرة والذاكرة بصريّاً في أعمالي، لا سيّما وأحاول تصوير تغيّر القصص حين يكون الناس في تحرّك. ولطالما كانت المرأة المصدر الرئيس لهذه القصص، فهي من ينقل الذكريات من جيل إلى آخر.
أيّ صورة تميلين إلى إظهارها حين ترسمين وجوه النساء في لوحاتك؟ وكيف تمكّنين النساء عبر أعمالك الفنيّة؟
يُعدّ رسم الوجوه من المواضيع الأكثر صعوبة، غير أنّني أحاول البدء من الصفر مع كلّ لوحة. فبصراحةً، لست مهتمّة إطلاقاً في إيصال أيّ رسالة واضحة عبر أعمالي. بل أحاول التحلّي بعقل منفتح أثناء رسم وجه شخصٍ ما، ليعمل ذهني بالتوازي مع اللوحة وأبدأ من الصفر في ذهني واللوحة أيضاً ثم أطوّرهما معاً، فهدفي الأساسيّ أن أغتنم اللحظة بكلّ ما فيها. وأعتبر أنّ الوحيد الذي أدين له بالصدق هو فرشاة الرسم خاصّتي. ولا يمكن الإنكار أنّ النساء عادةً ما يجدنَ طريقة للتأثير في الأعمال الفنيّة، لذا كلّ ما عليّ فعله هو الإصغاء بعناية لهنَّ وترجمة مُراد قولهنّ.
ما النصيحة التي تسدينها إلى النساء ليخترنَ اللوحات التزينيّة المناسبة لمنازلهنَّ؟
أعتبر كلمة "تزينيّة" صفة خاطئة بنظري. فالأمر غاية في البساطة ويقضي فحسب باختيار المرأة لوحة فنيّة تشبهها وتحرّك العواطف في نفسها. وفي هذه الحالة، سترغب في رؤيتها كلّ يوم، وستجد تلقائيّاً مكاناً لها في مساحة معيشتها. في هذا السياق، أذكر أنّ أحد محبّي الجمع هدم حائطاً كاملاً في غرفة طعامه لتتّسع اللوحة الفنيّة الضخمة التي أحضرها لوقوعه في حبّها. وأقرّ بأنّني أؤمن فعلاً بأنّ الجدران تستحقّ الهدم في سبيل الأفكار.
متى بدأت في جمع القبّعات والنظّارات الشمسيّة ولماذا؟
أشعر أحياناً بالحاجة إلى وضع الحواجز بيني وبين كلّ ما هو في الخارج، من الضجيج إلى النور والروائح وحتّى الأشخاص. وبدأ جمعي للقبّعات والنظّارات الشمسيّة كصورة من صور الحماية الشخصيّة، ثم تطوّر ليتحوّل إلى هوس صغير وبالتالي إلى مجموعة. فدائماً ما أنظر إلى الملابس والإكسسوارات على أنّها أزياء، وأحب التنكّر كثيراً. وليس الأمر بطريقة تعبير شخصيّة، إنّما هي في الحقيقة مجرّد وسيلة ممتعة لإطلاق العنان لمخيّلتي ومراقبة الحشد والمشاهدة من الخلف.
ما القصّة التي تحملها قلادة العصفور التي أعطتك إيّاها جدّتك وقلادة العملة المعدنيّة التي قدّمها والدك لكِ؟
منذ أكثر من قرن من الزمن، كان والد جدّي تاجراً مهمّاً وسافر كثيراً. ويُحكي أنّه أحبّ ابنته أي جدّتي كثيراً. وفي أحد الأيّام، أهداها أقراطاً على شكل طائرٍ صغير عقب عودته من تركيا. غير أنّ الأقراط أعجبت ابنة أخيه الصغيرة كثيراً لدرجة أنّ جدّتي طلبت منه تقديم الأقراط لها بدلاً منها. إثر ذلك، وقع والد جدّي المسكين في حيرة من أمره بين حبّه لابنته التي وعدها بهذه الهدية، والضغط الذي مارسه أخوه عليه ليقدّمها لابنته. لكن سرعان ما خطرت له فكرة رائعة! عملاً بها، قصد صائغ المجوهرات وطلب منه تحويل الأقراط إلى قلادتَين، ليقدّم قلادةً إلى كلّ فتاة من الفتيات وإعادة إحلال السلام داخل الأسرة. وورثت والدتي هذه القلادة عن والدتها وقدّمتها لي لاحقاً. وعن هذه القلادة، دائماً ما أقول إنّه يمكنني أن أفقد أيّ شيء بدون أن أهتم، إلّا أنّ فقدان هذه القلادة سيفطر فؤادي.
أمّا القلادة التي أعطاني والدي إيّاها فهي واحدة من آخر العملات المعدنيّة التي تم صكّها في مقاطعة طرابلس بين العام 1109 و1289 وتمثّل آخر العملات الباقية من ولايات الصليبيّين. وعن الحكاية التي تحلّها، أخبركم أنّه تمّ العثور على ثلاث عملات معدنيّة في الأرض إثر أعمال تنقيب جرت أخيراً بهدف وضع الأساسات لمبنى جديد. وأخذ والدي العملات الثلاث وصنع من كلّ منها قلادة ليقدّمها إلى بناته الثلاث. ربما التاريخ يعيد نفسه في عائلتي. وأوّد أن أقول أنّ القلادتان ثمينتان جداً في نظري، لأنّ والديّ يدعمانني في كلّ خطوة أقوم بها، حتى أنّ ممارستي الأعمال الفنيّة ساهمت في توثيق رباطنا أكثر. لكنّني أحتاج إلى أغراض ماديّة أرتديها حول عنقي كتحيّة لهما، فضلاً عن الوشم الذي يحمل أسماء أحبّائي على ذراعي. وأعتقد أنّني أرى الجسد كأداة أو لوحة فنيّة تخبر قصّة كلّ شخص. ولهذا السبب، أرى أيضاً أنّ الندبات والتجاعيد ميزة جميلة تشهد على عيشنا في هذه الحياة وقصدنا مختلف الأماكن، وخوضنا التجارب الجيّدة والسيّئة،وكبر عمرنا وسعادتنا في إظهار كلّ ذلك.
هل تعتبرين أنّ المشغل الموجود في منزلك امتداداً له؟
لا أجيد الطهي ولا أرغب في أن أكون ربّة منزل جيّدة، لكنّني أجيد ابتكار الأعمال الفنيّة. لذا، إنّني بحاجة إلى أن يشكّل مشغلي امتداداً طبيعيّاً لمساحة العيشة في منزلي. إذ أظنّ أنّه من المنطقي أن أمتلك منفذاً سهل على المكان الذي أفكّر فيه وأعمل وأمارس التأمّل وأقرأ وأستمع إلى الموسيقى والكتب السمعيّة وأحتسي القهوة في خلال فترات الراحة وأستمتع بالأوقات الجيّدة مع أسرتي وأصدقائي. ونظراً إلى أنّني أعتبر نفسي متطرّفة بعض الشيء، أميل إلى الإنكباب على العمل وأعتبر أنّ منزلي يشكّل امتدادا ً لمشغلي وليس العكس.
بمَ يختلف تصميم منزلك في بيروت عن تصميم منزلك هنا؟
لديّ شقة في منطقة جونيه في لبنان. ولا بدّ لي من الإقرار بأنّ أكثر ما أفتقده هو المنظر الذي تطلّ عليه غرفة معيشتي. وأعترف أيضاً بأنّني لم أقدّر وجود خليج جونيه وبحرها الأزرق أمامي، إلى جانب منظر الجبل في الخلف لأمتّع ناظريّ به طوال اليوم. وأجد لندن عاديّة جداً بالنسبة إلى ذوقي في بعض الأحيان. وفي الواقع لديّ منزلان ومشغلان، وأستمر في الذهاب ولإياب بينهما، ممّا جعلني أشكّك في نفسي من حيث الانتماء والهويّة والتراث. إذ يمكن للتنقّل أن يكون إيجابيّاً وسلبيّاً على حدّ سواء، فالأسباب وراء حدوثها كثيرة، لكن بصفتي فنّانة، أعتقد أنّه من الجيّد دائماً أن أشهد التغيير وأن أكون قادرة على رصده في ممارساتي الفنيّة.
هل يمكنك أن تسمّي لنا قطعة فنيّة أم قطعة زينة أحضرتها من بيروت إلى هذا المنزل؟
أحضرت سجّاداتي معي من لبنان. فهي سجّادات فارسيّة وشرقيّة، وكنت في أمسّ الحاجة إلى دفء ملمسها وألوانها لا سيّما في تلك الأيام الباردة في بريطانيا. وتذكّرني هذه السجادات بطفولتي وبإعجابي الدائم بحرفيّة أولئك النسّاجين القبليّين وبالقصص التي يروونها في الأنماط والأطر التي يعتمدونها في السجادات.
ما أكثر ما تحبّين تزيين منزلك به؟
أحبّ تزيينه بالكتب والنباتات والبسكويت النباتيّ.
اقرئي أيضاً: At Home مع Andrea Wazen